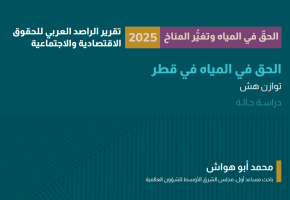نظرة على الحضور النسائي في إدارة الأزمات المناخية بالمغرب - حياة نديشي

نظرة على الحضور النسائي في إدارة الأزمات المناخية بالمغرب - حياة نديشي
يعرف المغرب أزمة مناخية حادة إذ سجل تراجعًا كبيرًا في نسبة التساقطات المطرية بنسبة 20% في العقود الثلاثة الأخيرة، وهو ما انعكس على الموارد الزراعية وانخفاضًا ملحوظًا في منسوب المياه الجوفية والسطحية، وزيادة الضغط على الموارد المائية المتوفرة. ففي عام 2022، سجل نصيب الفرد من المياه في المغرب حوالي 600 متر مكعب سنويًا، ويشير البنك الدولي إلى أن معدل الاستهلاك السنوي للفرد في المغرب سيبلغ 500 متر مكعب في عام 2024، وغير بعيد عن السياق الدولي، في حين أن المعيار العالمي لتجنب الإجهاد المائي هو 1000 متر مكعب لكل فرد سنويًا. هذه الأرقام المقلقة جعلت الدولة المغربية تواجه هذه التحديات باستراتيجيات عديدة بقيت في مجملها بعيدة عن تأمين الأمن الغذائي والمائي للأفراد وخاصة منهم النساء والفتيات.
لقد شكلت التغيرات المناخية في العقود الأخيرة مصدر قلق للعالم في مختلف ربوعه، لكونها تشكل تهديدًا خطيرًا على النظام البيئي وأسس التنمية المستدامة، وينعكس بشكل سلبي على الجهود المبذولة لمحاربة الهشاشة والفقر. و بالعودة إلى التقرير السادس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، نجد أنه حذر من أن ارتفاع درجات الحرارة والجفاف المتكرر والاضطرابات المناخية سيؤدي إلى انخفاض الإنتاج الزراعي بنسبة قد تصل إلى 30% في بعض المناطق الإفريقية، مما ينعكس على سبل العيش والأمن الغذائي لملايين الأشخاص بما فيهم النساء اللواتي يعتبرن صديقات للبيئة، كما أشار لذلك (التغير المناخي: النساء والبيئة) والصادر عام 2020، والذي أوضح أن النساء، وفقًا لأنماط حياتهن اليومية، يساهمن في انبعاثات أقل للغازات المسببة للاحتباس الحراري مقارنة بالرجال.
ويرتبط ذلك بعوامل مثل استخدامهن الأكثر لوسائل النقل العام، وإنفاق أقل على السيارات والسفر الجوي والسلع كثيفة الاستهلاك للطاقة. هذه الفروقات لا تعني أن النساء يتمتعن بصفات بيئية أفضل بطبيعتهن، بل تعكس تأثير الأدوار الاجتماعية والاقتصادية على سلوك الأفراد، وتبرز أهمية مراعاة هذه الفروقات عند تصميم السياسات البيئية لضمان العدالة في الاستجابة للتغير المناخي.
وفي نفس المنحى، شددت أجندة التنمية المستدامة في الأهداف: الأول (القضاء على الفقر)، الثاني (القضاء على الجوع)، والسادس (المياه النظيفة والنظافة الصحية) على ضرورة إدماج بعد النوع في السياسات المناخية والبيئية، ووعيًا منها بكون التغيرات المناخية تؤثر بشكل غير متكافئ على النساء والفتيات.
ولعل الحديث عن موضوع الأمن الغذائي والمائي بالمغرب يستوجب منا وضع الأصبع على المقصود بهما، حيث يقودنا الأول وحسب ما خلص إليه مؤتمر القمة العالمي للأغذية الذي عقد في عام 1996، بكونه وضع يتحقق عندما يتمتع جميع الناس، في جميع الأوقات، بإمكانية الحصول المادي والاقتصادي على أغذية كافية وسليمة ومغذية تلبي احتياجاتهم الغذائية وأفضلياتهم الغذائية من أجل حياة نشطة وصحية. أما الأمن المائي فيعني ضمان توفر المياه بجودة وكميات كافية لتلبية احتياجات الإنسان والحيوان والزراعة والصناعة، مع ضمان استدامتها للأجيال المقبلة. وعندما يرتبط المفهومان بالنوع الاجتماعي، يصبح المقصود قدرة النساء والفتيات على الوصول العادل إلى الموارد الغذائية والمائية، والقدرة على اتخاذ القرار، والاستفادة منها بشكل مستدام، دون تمييز بسبب الجنس.
إن تحليل المفهومين يوضح أن الاحتباس الحراري واختلال التوازن البيئي يجعلان قضية الوصول وسلطة القرار في تدبير الموارد والثروات المائية والغذائية أمرًا صعبًا ومتشابكًا كلما تعلق الأمر بالنساء والفتيات. ورغم الجهود المبذولة لمواجهة التحديات البيئية والمناخية بتبني استراتيجيات وطنية كبرى، إلا أن الأثر ظل غير شامل لمختلف الفئات خاصة في سياق الأمن الغذائي والمائي.
ويمكن أن نذكر هنا على سبيل المثال لا الحصر: مخطط المغرب الأخضر، الذي بالرغم من إيجابياته في تحديث القطاع، إلا أنه ساهم في تركيز الدعم بشكل كبير على الزراعات التصديرية، مما أدى إلى زيادة تهميش صغار الفلاحين، وغالبيتهم نساء، من فرص الاستثمار وملكية الأرض. ثم استراتيجية الجيل الأخضر التي عرفت قفزة نوعية في استهداف النساء القرويات ووضعتهن في صميم أولوياتها عبر تسهيل وصولهن إلى تمويل التعاونيات وتشجيع المقاولة النسائية في المجال الزراعي الصديقة للبيئة والمقاومة للتغييرات المناخية، لكنها لازالت حتى اليوم لم تتمكن من تعزيز ولوج النساء إلى ملكية الأراضي والتأثير في سد الفجوة بين الجنسين في شق الأمن الغذائي.
وفي سياق الحديث عن الأمن المائي، اتخذت الدولة المغربية خطوات مهمة لمواجهة أزمة الولوج إلى الماء، من بينها الاستراتيجية الوطنية للماء 2030. ورغم مساهمتها في تحسين فرص الوصول إلى المياه الصالحة للشرب، إلا أنها لم تنجح في تحقيق التوازن بين المناطق الحضرية والقروية، حيث ظلت هذه الأخيرة أكثر عرضة لتقلبات المناخ وتراجع الموارد.
كما تعددت السياسات والخطط التي حاولت إدماج العدالة المناخية للنساء ضمن رؤيتها الاستراتيجية، لكنها بقيت عاجزة عن بلورة تصور شمولي يأخذ بعين الاعتبار الفجوات المجالية، سواء بين النساء والرجال أو بين فئات النساء أنفسهن (شابات، مسنات، مهاجرات، في وضعية إعاقة، أمهات عازبات، نساء الواحات، نساء الجبال...). ويُعزى هذا الأثر المحدود في ضمان أمن غذائي ومائي للنساء إلى عدة عوامل، أبرزها غياب التنسيق بين السياسات العمومية والترابية المعنية بتمكين النساء، واستمرار التفاوت في الملكية الاقتصادية، بما في ذلك ملكية الماء والأراضي، سواء الخاصة أو التابعة للدولة بنظام التفويت الجماعي، كما تقل فرص النساء في الاستفادة من الدعم الحكومي للاستثمار الفلاحي، ويظل نظام القروض غير ملائم للفجوات الاقتصادية، ولا يراعي وضعية النساء ولا الثقافة المجتمعية التي تحصرهن في أدوار غير إنتاجية، مما يؤدي إلى تسجيل الموارد بأسماء الرجال. ونتيجة لذلك، يبقى اعتماد النساء على الاقتصاد المعيشي المرتبط أساسًا بالتساقطات المطرية، ما يجعلهن الأكثر تأثرًا بموجات الجفاف ونقص المياه.
إن البنية الاقتصادية والاجتماعية المغربية لا تحول فقط دون استفادة النساء من ملكية الغذاء عبر ملكية الأراضي، بل أيضًا تجعلهن يتحملن عبء جلب الماء في المناطق التي لا تتوفر على شبكة تزويد بالماء الشروب، والذي أصبح يتطلب ساعات أكثر لشح المياه الجوفية وجفاف العديد من الآبار والوديان، ويعرضهن لرحلات عذاب يومية، ويحرم الفتيات من فرص النجاح في التعليم، ويحرم النساء أيضًا من حقهن في ممارسة حياتهن الحميمة مع شركائهن.
هذه الإشكاليات كلها، بالإضافة إلى ضعف البنية التحتية الصحية في المناطق المتضررة بالجفاف، تؤثر سلبًا على صحة النساء الجسدية والجنسية وعلى خصوبتهن وقدرتهن على الإنجاب، وانتشار بعض الأمراض في أوساطهن، خاصة الأمراض الجلدية أو المناعية بسبب سوء التغذية وغياب النظافة، خاصة النساء الحوامل والمرضعات والفتيات في مقتبل العمر. هذا بالإضافة إلى أن موجات الحرارة والجفاف وتلوث المياه يساهم في تفاقم أعباء النساء النفسية نتيجة القلق المرتبط بإعالة الأسرة في ظروف غير مستقرة.
وتتعدى آثار التغيرات المناخية في المغرب البعد البيئي لتطال البنية الاجتماعية والعلاقات رجال/نساء، وتؤدي إلى تكريس التفاوتات بين النساء والرجال، خاصة في المناطق القروية والجبلية. فمع ازدياد ندرة المياه وتراجع الإنتاج الفلاحي، تتقلص فرص الشغل والدخل المتاحة للنساء، ما يدفع العديد منهن إلى الاعتماد الاقتصادي على الرجال أو إلى الهجرة القروية نحو المدن بحثًا عن موارد بديلة، غالبًا في قطاعات هشة كالعمل المنزلي أو العمل غير المهيكل. هذا التحول يفاقم معدلات الفقر النسائي ويقلص من استقلاليتهن الاقتصادية، ما ينعكس سلبًا على قدرتهن في اتخاذ القرار داخل الأسرة والمجتمع.
ولا تنحصر أزمة الغذاء والماء التي تعيشها النساء في المغرب عند حدود الثقافة الاجتماعية والاختلال المناخي، بل تمتد إلى أثر تغييبهن عن التمثيل في مراكز القرار العمومي والترابي وفي اللجان المحلية لتدبير الأزمات المناخية والمائية، وهو ما دفع البعض منهن إلى الخروج في حركة احتجاجية نسائية بفجيج للمطالبة بالحق في الولوج إلى الماء وعدم تفويض تدبيره للقطاع الخاص، والمساهمة في تدبيره عبر الانخراط في لجان. التدبير عبر سياسة دامجة تضع النساء كجزء من الحل، لا فقط كمستفيدات، بل كفاعلات أساسيات في تدبير الموارد الطبيعية وصناعة القرار البيئي.
نخلص مما سبق أن تحقيق الأمن الغذائي والمائي للنساء ومواجهة التغيرات المناخية يتطلب اعتماد سياسات دامجة لبعد النوع وللعدالة المجالية، وتطبيق استراتيجيات تحويلية لا تكتفي بالإغاثة المؤقتة، بل تركز على بناء المرونة على المدى الطويل، بما يتماشى مع الروح التحويلية لأهداف التنمية المستدامة، من تحسين للبنية التحتية للمياه خاصة في المناطق القروية وهوامش المدن، إرساء مؤشرات قياس حسب النوع ضمن التقارير الوطنية حول المناخ والتنمية المستدامة، وتطوير المعرفة في صفوف النساء، وتعزيز تمثيليتهن في إدارة الموارد مع الأخذ بعين الاعتبار وضعية الكوارث والأزمات ومواسم الجفاف في برامج الحماية الاجتماعية.
إن الأمن الغذائي والمائي للنساء ليس مجرد قضية غذاء وماء، بل مسألة عدالة وحقوق إنسانية. ضمان الوصول إلى الموارد وإشراك ودمج النساء في صناعة القرار لم يعد أمرًا مرحليًا، بل رافعة لتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وضرورة لضمان تنمية مستدامة ومجتمع أكثر عدالة.
[1] https://rosaluxna.org/ar/publications
[2] يُعرَّف الإجهاد المائي عالمياً بأنه الحالة التي يقل فيها نصيب الفرد من المياه العذبة المتجددة عن 1000 متر مكعب سنوياً، وهو الحد الأدنى لضمان تلبية الاحتياجات الأساسية من الشرب والصحة والزراعة. منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) والمعهد الدولي لإدارة المياه (IWMI)
[3] اسم التقرير: "Area K: Women and the Environment – Climate Change is Gendered"، وهو جزء من مراجعة تنفيذ منهاج عمل بيجين في الاتحاد الأوروبي، نُشر من قبل المعهد الأوروبي للمساواة بين النساء والرجال (EIGE) في مارس 2020
[4] https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/sustainable-development-goals/
احدث المنشورات

النشرة الشهرية كانون الثاني/يناير - من دافوس إلى الاستعراض الدوري الشامل: بين الالتزامات والمساءلة