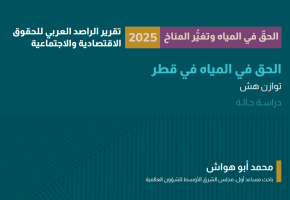تونس على مفترق الطرق: لحظة كينزية من أجل عدالة ضريبية – أمين بوزيان
خلال السنوات الأخيرة، عانت تونس من سلسلة من الصدمات الخارجية غير المسبوقة. فقد شكّلت جائحة كوفيد-19، تلتها الحرب في أوكرانيا، ضغطًا شديدًا على التوازنات المالية وفاقمت هشاشة اقتصاد كان يعاني أصلًا من ضعف هيكلي.
يرجع انخراط تونس في السياسات النيوليبرالية إلى برنامج التكييف الهيكلي الذي اعتُمِد عام 1986 بدفع من المؤسسات المالية الدولية. وقد كرّست “الإصلاحات” التي تبعته هذا النموذج الاقتصادي، في تناقض مع تطلعات المسار الثوري الذي انطلق في ديسمبر 2010. ومع ذلك، واصلت الحكومات المتعاقبة تعزيز تعاونها مع هذه المؤسسات، لا سيما من خلال برامج متعددة مع صندوق النقد الدولي، مساهمة بذلك في إجهاض المطالب الشعبية. ووجدت تونس نفسها محاصرة في حلقة مفرغة من المديونية والتقشف.
ثم جاءت جائحة كوفيد-19 لتزيد الوضع سوءًا: نمو سلبي بلغ -8.6% سنة 2020، وعجز قياسي في الموازنة وصل إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي منذ السنة الأولى للأزمة، وتضاعف ثلاثي في كلفة الدعم إثر الغزو الروسي لأوكرانيا. فقد بلغت هذه الإعانات 12 مليار دينار في عام 2022، أي 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي، في وقت كانت تونس تواجه فيه استحقاقات غير مسبوقة لسداد ديونها الخارجية.
فقد ارتفعت خدمة الدين الخارجي من معدل سنوي بلغ 3.5 مليار دينار بين 2011 و2020 إلى 7.7 مليارات في 2021، و6 مليارات في 2022، وصولًا إلى 8.7 مليارات في 2023. وفي العام نفسه، بلغ الدين العمومي 83% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى مستوى في التاريخ الحديث للبلاد. كما شهد عام 2023 قطيعة مع صندوق النقد الدولي، حين رفضت تونس رسميًا، في 6 أبريل، البرنامج البالغ 1.9 مليار دولار، والذي كان قد تم التوصل بشأنه إلى اتفاق على مستوى الخبراء في 15 أكتوبر 2022.
تجميد التوظيف والأجور في الوظيفة العمومية، إلى جانب الإلغاء الكلي لدعم الأسعار، شكّلت جزءًا من الوصفة التقشفية لهذا البرنامج، المبررة أساسًا بضرورة استعادة التوازنات المالية.
قرار رفض البرنامج فتح سابقة غير معهودة، إذ تمكنت تونس من إعادة مؤشرات الموازنة إلى مستويات قريبة من تلك التي حددها برنامج الصندوق، لكن عبر مسار آخر، أي من خلال زيادة الإيرادات الضريبية والاعتماد المتزايد على الاقتراض المحلي. ورغم أن ذلك سمح لتونس بتفادي صدمة تقشفية ذات عنف اجتماعي غير مسبوق، إلا أن هذا الخيار ظل محدودًا. فحشد الموارد الداخلية بقي مجزأً وغالبًا مقيدًا، واعتماد الضريبة التصاعدية كان متواضعًا، كما أن الاستجابة التونسية لم ترتقِ إلى مستوى استراتيجية اقتصادية طويلة الأمد. لقد قالت تونس "لا" لبرنامج صندوق النقد الدولي، دون أن تتحرر في الواقع من النموذج الكامن وراءه.
وهذا يفرض على تونس التزامًا مزدوجًا: تحفيز الاقتصاد الوطني عبر الاستثمار العمومي وضمان تمويله من خلال نظام ضريبي أكثر عدالة، خصوصًا تجاه الأثرياء.
تونس بحاجة إلى "لحظة كينزية"
يجب أن تعيش تونس “لحظتها الكينزية”. أي أن تقطع مع التقشف الاقتصادي وتتخلى عن حيادها الموروث عن خطة التكييف الهيكلي، التي حبستها في منطق نيوليبرالي يترك السوق يقرر كل شيء. وتزداد هذه القطيعة إلحاحًا لأن الدول الأكثر ثراءً أعادت في مرحلة ما بعد كوفيد استخدام الأدوات الكينزية لإحياء اقتصاداتها، في حين لا تزال هذه المقاربة غائبة إلى حد كبير عن السياسات العامة التونسية. فالنفقات العمومية على الاستثمار تتقدم بخطوات بطيئة وبقيت هامشية، إذ ارتفعت من 4.7 مليارات في 2023 إلى 5.2 مليارات في 2024، ومن المتوقع أن تصل إلى 5.4 مليارات في 2025، أي ما يعادل بالكاد 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي. من هنا بالتحديد يجب أن يحصل التحول، ليس من أجل هدنة اقتصادية مؤقتة تعيد إنتاج النموذج النيوليبرالي لاحقًا، بل لتحقيق أهداف استراتيجية، أهمها تعزيز السيادة الغذائية والطاقية باعتبارهما رافعتين أساسيتين للاقتصاد التونسي. فالزراعة، التي لا تزال تُدار ضمن منطق الأمن الغذائي، تكرّس حاليًا تبعية البلاد لأسواق واحتياجات بلدان الشمال. على الدولة أن تستعيد منظور التخطيط طويل الأمد، لتمنح الفاعلين الاقتصاديين رؤية واضحة وتتيح تحقيق أهداف طموحة تتمحور حول حاجات السكان.
وإذا كانت آفاق السيادة الغذائية والطاقية تستدعي على الأرجح استعادة جزء من السيادة النقدية لتمويلها، فإن فرض ضرائب على الأغنياء يظل حلًا لا غنى عنه على المدى القصير والمتوسط.
من أجل عدالة ضريبية في خدمة الصالح العام
في هذا المجال أيضًا، شكّل برنامج التكييف الهيكلي نقطة تحول في السياسات الضريبية التونسية. فقد أُفرغت تصاعدية ضريبة الدخل من مضمونها، وخُفضت ضرائب أرباح الشركات بشكل كبير، وهُمشت الضريبة على الثروة، وفُككت الرسوم الجمركية، بينما توسع الاعتماد على الضرائب غير المباشرة على الاستهلاك. ومنذ رفض برنامج صندوق النقد، لم تغيّر الحكومات التونسية هذا المسار إلا بشكل خجول. فقد تم تعزيز سلم ضريبة الدخل بإضافة ثلاث شرائح جديدة، ورفع معدل الضريبة الأعلى من 35% إلى 40%، وزيادة معدل الضريبة العام على الشركات من 15% إلى 20%، ورفع المعدل الخاص بالبنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية من 35% إلى 40%. كما تم إقرار ضريبة على الثروة العقارية، إلى جانب تدابير أخرى ظرفية أو دائمة تستهدف فئات محددة من المكلّفين. وقد ساهمت هذه الإصلاحات في تقليص الفجوة بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة من 18.8% في 2022 إلى 14.4% في 2025، مع بقاء هامش واسع لإرساء سياسة ضريبية تصاعدية حقيقية.
يمكن سد هذا الهامش عبر الإجراءات التالية:
-
إعادة إرساء تصاعدية حقيقية لضريبة الدخل، بحيث يساهم أصحاب الدخل المرتفع وفق قدرتهم الفعلية؛
-
مواءمة ضريبة رأس المال مع ضريبة العمل، لتقليص الفوارق التي يكرسها الامتياز الضريبي للأرباح الموزعة والدخول المالية؛
-
تعزيز ضريبة الثروة عبر شمول الأصول المالية، مع عتبة خضوع أكثر واقعية وجدول ضريبي متمايز؛
-
تقليص الامتيازات الضريبية المكلفة وغير الفعالة، التي تحرم الدولة من مليارات الدنانير وتصب في مصلحة أقوى الفاعلين؛
-
مكافحة فعالة للتهرب والغش الضريبيين، عبر تعزيز قدرات الإدارة والنظام القضائي.
هذه الإصلاحات لا تقتصر على مجرد تعديلات تقنية، بل تمثل تحولًا حقيقيًا في النموذج: الانتقال من منطق التنافسية الضريبية، الذي أضعف قدرة الدولة على إعادة التوزيع، إلى منطق العدالة الضريبية. وهو التحول الذي سيتيح تمويل انتعاش اقتصادي شامل، وإعادة ثقة المواطنين في الضريبة كأداة للتضامن الوطني.
احدث المنشورات

النشرة الشهرية كانون الثاني/يناير - من دافوس إلى الاستعراض الدوري الشامل: بين الالتزامات والمساءلة