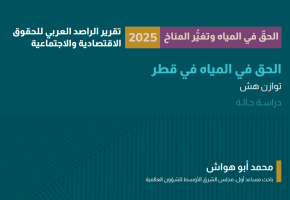الأردن وصندوق النقد الدولي: من الإنقاذ إلى الاعتمادية - أحمد عوض

الأردن وصندوق النقد الدولي: من
الإنقاذ إلى الاعتمادية - أحمد
عوض
منذ عام 1989، شكّل التعاون بين الأردن وصندوق
النقد الدولي (IMF)
محوراً رئيسياً للسياسات الاقتصادية الأردنية. بدأت هذه العلاقة مع أزمة مالية
حادة، دُفع الأردن على إثرها إلى أول اتفاق من نوعه مع الصندوق، واضعاً نفسه على
مسار التكييف الهيكلي والانضباط المالي. ومنذ ذلك الوقت، دخلت البلاد في تسعة
برامج متتالية على الأقل، تضمنت وصفات سياسية ومالية ذات طابع تقشفي نيوليبرالي،
تحت مظلة ما عُرف بـ"تفاهمات واشنطن".
وقد كان الهدف المعلن لتلك البرامج تحقيق
الاستقرار المالي والنقدي، وخفض عجز الموازنة العامة، وتقليص المديونية، وتحقيق
النمو الشامل، والحد من الفقر والبطالة. غير أن التجربة على مدى أكثر من ثلاثة
عقود أثبتت أن النجاح الأبرز لتلك البرامج لم يتجاوز تمكين الأردن من الاستمرار في
سداد التزاماته المالية تجاه الدائنين، وهو الهدف الفعلي الذي يبدو أن الصندوق
يركز عليه فعلياً، رغم الخطاب الذي يتحدث عن الاستدامة والاستقرار الماليين.
فمنذ بدء العلاقة، ارتفع الدين العام الأردني من
نحو 5.8 مليار دولار في عام 1989 إلى أكثر من 50 مليار دولار في عام 2024، أي ما
يفوق 115 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما بقي عجز الموازنة قبل المنح
مرتفعاً، حيث بلغ نحو 6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، وفقاً لبيانات
وزارة المالية الأردنية.
تركت برامج الصندوق بصمتها على مختلف مجالات
السياسات العامة، بدءاً من تقليص دور الدولة في تقديم الخدمات العامة، ومروراً
بسياسات الخصخصة، وانتهاءً بسياسات ضريبية عمقت العبء على الطبقة الوسطى والفقيرة.
فقد أصبحت الضرائب غير المباشرة (الضريبة العامة
على المبيعات والضرائب المقطوعة والرسوم بمختلف أنواعها) تمثل نحو 75 بالمائة من
مجمل الإيرادات الضريبية، في حين أن ضريبة الدخل تمثل ما يقارب 4 بالمائة من
الناتج المحلي، مما يعكس نظاماً ضريبياً غير عادل يُثقل كاهل المستهلكين ويضغط على
القدرات الشرائية لغالبية المجتمع، ويضعف الطلب الكلي على الاستهلاك.
وقد ساهمت هذه السياسات في تدهور مؤشرات العدالة
الاجتماعية، حيث ارتفعت معدلات الفقر من 9 بالمائة عام 2002 إلى ما يقارب 24
بالمئة في عام 2022 حسب الحكومة، و35 بالمئة حسب البنك الدولي، في حين قاربت
البطالة 22.0 بالمائة في عام 2024، مع تفاوت حاد في فرص العمل بين الجنسين
والشباب.
غالباً ما بررت الحكومات الأردنية المتعاقبة
التزامها الصارم ببرامج الصندوق باعتبارها شرطاً للحصول على التمويل الدولي من
مصادر متعددة، وللحفاظ على الاستقرار النقدي والسياسي. وقد استخدمت حكومات عدة
خطاب “الإصلاح” للترويج لهذه البرامج، رغم فشلها المتكرر في تحقيق الأهداف
المعلنة.
ومع نهاية كل برنامج، يدخل الأردن مفاوضات جديدة
لبرنامج آخر، كما حدث عام 2025، عندما قررت الحكومة تجديد الاتفاق للمرة العاشرة،
في وقت لم تُحل فيه الأزمات البنيوية التي يعاني منها الاقتصاد.
على النقيض من الموقف الرسمي، يتبنى العديد من
الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني خطاباً ناقداً لهذه العلاقة الممتدة مع
صندوق النقد، ويرون فيها امتداداً لسياسات مفروضة لا تراعي السياق المحلي، وتفاقم
الأزمات بدل حلها. ويتعرض صندوق النقد لانتقادات متزايدة بسبب درجة
"الشرطية" العالية في برامجه، التي تفرض على الأردن تنفيذ سياسات ضريبية
وتقشفية قاسية، مثل رفع أسعار الكهرباء والوقود وتحرير الأسعار، من دون مراعاة
للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
يطرح المجتمع المدني مطلباً ملحاً بأن على
الصندوق مراجعة توجهاته، وأن يعيد صياغة سياساته وفق مفهوم "النمو
الشمولي" الذي يحقق توزيعاً أكثر عدلاً لثمار النمو ويقلص فجوات التفاوت.
ويبدو واضحا أن تدخلات وبرامج الصندوق فاقمت
التفاوت الاجتماعي، ودفعت باتجاه تقليص الحماية الاجتماعية من خلال أضعاف معايير
العمل وتأمين الشيخوخة في إطار منظومة الضمان الاجتماعي، وأضعفت قدرة الدولة على
الاستثمار في التعليم والصحة والنقل، واستمرار الضغط على الأجور.
في الواقع، وعلى الرغم من فترات نمو اقتصادي
نسبي، فإن هذا النمو غالباً ما كان هشاً، وغير شامل، وغير قادر على توليد فرص عمل
كافية. ولم يُترجم إلى تحسن في مستويات المعيشة، حيث استمر ارتفاع البطالة والفقر
وتراجع الخدمات العامة.
في الوقت الذي يدعو فيه صندوق النقد الدولي إلى
حماية الفئات الضعيفة والنمو الشمولي، نجد أن سياساته المفروضة تفضي إلى نقيض ذلك
تماماً. فقد أسهمت إجراءات "الإصلاح" في إضعاف الأجور في القطاع العام،
وإدخال سياسات عمل مرنة أضعفت شروط العمل، وضربت ببيئة العمل العادلة عرض الحائط.
كما أن الاستثمار في رأس المال البشري تراجع. إذ
تعاني المدارس والمستشفيات من نقص في الكوادر والتمويل، ما أثر على جودة هذه
الخدمات بشكل ملموس.
تظهر تجربة الأردن مع صندوق النقد أن تحقيق
الاستقرار النقدي لا يعني بالضرورة تنمية شاملة أو استدامة مالية. ومع توقيع اتفاق
جديد، يصبح من الضروري أن يخضع المسار السابق لتقييم نقدي صريح، تشارك فيه
الحكومة، والخبراء، والمجتمع المدني، لتحديد اتجاه مختلف.
على الأردن أن يطالب بإدخال مرونة أكبر على
سياسات الصندوق، تتناسب مع أولوياته التنموية، وأن يعيد ترتيب أولوياته من خلال
تعزيز الإيرادات الضريبية العادلة، وتوسيع الحماية الاجتماعية، وتطوير سياسات
تحفيزية تقوم على تعزيز الطلب الاستهلاكي.
إن استمرار اعتماد الأردن على الاقتراض لا يمكن
أن يكون حلاً دائماً، خاصة وأن خدمة الدين العام وحدها باتت تلتهم ما يقارب 17
بالمائة من الموازنة. كما أن النمو غير الشامل، وزيادة التفاوت الاجتماعي، وركود
الأجور، وتراجع الخدمات العامة كلها مؤشرات على أن وصفات الصندوق لا تتوافق مع
احتياجات الأردن الحقيقية.
وقد حان الوقت للانتقال من منطق "التوازنات المالية" إلى منطق "العدالة الاقتصادية والاجتماعية"، ولإعادة تعريف العلاقة مع المؤسسات المالية الدولية بما يخدم التنمية المستدامة والمجتمع الأردني بأكمله.
تنويه:
نُشر هذا المقال ضمن النشرة الشهرية بعنوان "سياسات صندوق النقد الدولي: لا قاعدة ثابتة". الآراء والأفكار الواردة هنا تعبّر عن رأي الكاتب/ة فقط، ولا تعبّر بالضرورة عن الموقف الرسمي للشبكة.
احدث المنشورات

النشرة الشهرية كانون الثاني/يناير - من دافوس إلى الاستعراض الدوري الشامل: بين الالتزامات والمساءلة