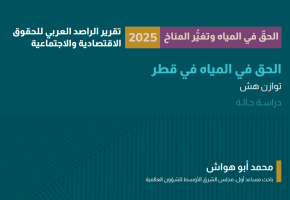أزمة المديونية في العالم العربي: بين السيادة المالية والحقوق الاجتماعية - زياد عبد الصمد
زياد عبد الصمد
أزمة المديونية في العالم العربي: بين السيادة المالية والحقوق الاجتماعية - زياد عبد الصمد
مقدمة
تعاني العديد من الدول في المنطقة العربية من أزمات مديونية خانقة، تتجاوز كونها تحديات اقتصادية لتتحول إلى قضايا تمس جوهر السيادة الوطنية وحقوق الإنسان الأساسية. فالمديونية لم تعد مجرد أرقام ونسب، بل واقع يومي ينعكس على قدرة المواطنين في الحصول على الخدمات الأساسية من تعليم وصحة وسكن، ويؤثر بشكل مباشر على فرصهم في العيش الكريم والمشاركة السياسية الفاعلة.
أولًا: المديونية وتآكل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
ارتبطت أزمة الديون في المنطقة العربية بتبني سياسات تقشفية قاسية، غالبًا ما فرضتها برامج الإصلاح المقرونة بشروط المؤسسات المالية الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي. وقد أدّت هذه السياسات إلى:
• تراجع ملحوظ في الإنفاق على التعليم والصحة:
حيث لا يتجاوز متوسط الإنفاق الصحي في الدول العربية (باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي) 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو دون المعدلات العالمية. أما الإنفاق على التعليم فكان مماثلًا لمستوى البلدان النامية، لكنه لم يلبِّ بعد متطلبات الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بضمان جودة التعليم.
• انكماش برامج الحماية الاجتماعية:
حيث اقتصر الدعم على شبكات الأمان الاجتماعي التي تطال الأسر الأكثر فقرًا وبعض الفئات كالأشخاص ذوي الإعاقة والأسر التي ترأسها نساء، وذلك في أفضل الأحوال.
• ارتفاع معدلات البطالة، خاصة في أوساط الشباب والنساء:
في ظل غياب برامج حماية للبطالة، ما يؤدي إلى هجرة الشباب ونزيف الأدمغة الذي تعاني منه معظم الدول العربية.
• تصاعد مستويات الفقر وانعدام المساواة في توزيع الدخل والثروة:
حيث يستحوذ 1% من السكان في المنطقة على أكثر من 43% من مجمل الثروة.
هذه الانعكاسات لم تكن فقط نتيجة ضغوط مالية، بل عكست ضعفًا بنيويًا في النظم الضريبية، وافتقارًا للتخطيط الاقتصادي العادل، وارتباطًا هشًا بالاقتصاد العالمي دون قدرة إنتاجية مستقلة.
ثانيًا: البعد السياسي وفقدان الحيّز السيادي
المديونية بهذا الحجم لا تُقيّد فقط القرار المالي، بل تُقوّض السيادة الوطنية، بحيث تصبح الدول خاضعة لشروط ومفاوضات متواصلة مع صندوق النقد الدولي وجهات مانحة أخرى. وغالبًا ما تركز هذه الشروط على إصلاحات مالية تقشفية، بدلًا من خطط تنموية عادلة.
وهنا تبرز معضلة الحيّز السياسي الضيّق:
تُناقش السياسات المفصلية خارج المؤسسات المنتخبة، من دون نقاش عام أو شفافية كافية. وغالبًا ما تُمرر اتفاقيات القروض أو شروط التمويل عبر قرارات حكومية أو مراسيم، لا من خلال قرارات تشريعية مدروسة، مما يُضعف آليات المساءلة والمشاركة الديمقراطية.
ثالثًا: نحو مقاربة حقوقية لإدارة الدين
ندعو إلى تبني منظور حقوقي في إدارة الديون، يستند إلى:
• تقييم الأثر الحقوقي (Human Rights Impact Assessments) لكل سياسة اقتصادية أو اتفاق لإعادة الهيكلة.
• وضع خطوط حمراء اجتماعية لا يجوز تجاوزها، مثل التعليم المجاني، والرعاية الصحية، والحماية للفئات الهشة.
• مشاركة المجتمعات المتأثرة في تصميم وتنفيذ برامج الإصلاح، انطلاقًا من مبدأ أن الناس ليسوا "مستفيدين" بل أصحاب حقوق.
إن تجاهل هذه المبادئ – كما حدث في الأرجنتين وزامبيا – أدى إلى آثار اجتماعية مدمّرة، وموجات احتجاج شعبي، وفقدان شرعية المؤسسات السياسية.
رابعًا: إعادة تعريف "استدامة الدين"
عادة ما يُعرّف مفهوم "استدامة الدين" ضمن الأدبيات الاقتصادية باعتباره القدرة على السداد فقط. لكننا نرى أن الاستدامة يجب أن تشمل:
• القدرة على تمويل الخدمات الاجتماعية.
• تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
• المرونة في مواجهة الأزمات (أوبئة، تغير مناخي، نزاعات).
بحسب تقرير الاستثمار العالمي لعام 2024، تُقدّر فجوة التمويل المطلوبة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول النامية بنحو 4 تريليونات دولار سنويًا.
وفي العالم العربي، لم تحقق 14 دولة هدفًا واحدًا من أهداف التنمية المستدامة. ويُقدّر أن بلوغ هذه الأهداف قد يتأخر 60 عامًا إضافية إذا استمرت الاتجاهات الحالية.
وقد دعا الأمين العام للأمم المتحدة مؤخرًا إلى اعتماد مقاييس بديلة للناتج المحلي الإجمالي تعطي الأولوية لرفاهية الإنسان والكوكب، معتبرًا أن:
"اعتماد مؤشرات تُكمل الناتج المحلي الإجمالي يمكن أن يُحدث تحولًا جذريًا في صنع السياسات، يعيد تركيز الجهود على التنمية المستدامة والازدهار للجميع."
خامسًا: الأسباب البنيوية لأزمة المديونية
أزمة الديون ليست دائمًا نتيجة الإفراط في الإنفاق، بل كثيرًا ما تكون نتيجة:
• اقتصاد ريعي هش يعتمد على صادرات أولية أو تدفقات مالية غير مستقرة.
• ضعف السياسات الضريبية، مع اعتماد كبير على الضرائب غير المباشرة، مما يزيد من الظلم الاجتماعي.
ففي عام 2022، لم يتجاوز متوسط الإيرادات الضريبية في دول مثل الجزائر، مصر، لبنان، العراق، السودان، اليمن، والأردن نسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 22% في تونس والمغرب، و30.04% في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
أما متوسط الضرائب المباشرة فبلغ حوالي 4.2% فقط، مقارنة بـ13.86% في دول OECD.
• اندماج غير متوازن في الاقتصاد العالمي، دون تنويع إنتاجي أو تصنيع محلي، مع ميل كبير للاستيراد.
|
ملحق خاص: لبنان نموذجًا لتشابك الدين والانهيار
الحقوقي |
|
يُعد لبنان
مثالًا حيًا على الترابط بين أزمة المديونية وتدهور الحقوق الاقتصادية
والسياسية. إذ بلغ الدين العام في السنوات الأخيرة أكثر من 95 مليار دولار، أي
ما يتجاوز 280% من الناتج المحلي، بحسب صندوق النقد الدولي، مما يجعله من أعلى
معدلات الدين في العالم. - الأثر السياسي: خضوع متزايد وفقدان السيادة أصبحت القرارات
المالية الكبرى مرتهنة لمفاوضات مع صندوق النقد الدولي والجهات المانحة، تُدار
غالبًا خارج الأطر الدستورية ومن دون رقابة برلمانية أو نقاش عام، مما يُضعف
الشفافية ويهمّش المشاركة الديمقراطية. - الأثر الاجتماعي: انهيار كامل للحقوق الأساسية منذ الانهيار
المالي عام 2019، تراجعت القدرة الشرائية بأكثر من 90%، وبلغ الفقر أكثر من 80%. وقبل التعثر في
السداد عام 2020، خُصص نحو 5 مليارات دولار سنويًا لخدمة الدين، وهو مبلغ يفوق
مجمل الإنفاق على الصحة والتعليم مجتمعين. ورغم تعليق دفع
الديون الخارجية، لم تُستثمر الوفورات لتحسين الواقع الاجتماعي، بل تم الدفع نحو
سياسات تقشفية طالت الفئات الأضعف ورواتب الموظفين والمتقاعدين. - خيارات بديلة واقعية التقشف ليس
الخيار الوحيد. يمكن للبنان اعتماد سياسات وطنية عادلة تشمل: 1. إصلاح ضريبي جذري يضمن عدالة التوزيع، مع اعتماد
ضرائب تصاعدية وفرض رسوم على الاستثمارات في الأملاك البحرية والعامة. 2. توسيع القاعدة الضريبية ومكافحة التهرب، حيث
تُقدّر الخسارة السنوية من التهرب الضريبي بنحو 5 مليارات دولار. 3. ترشيد الإنفاق العام والحد من الهدر والفساد. 4. تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الدين
والمالية العامة، بدءًا بتفعيل دور القضاء ومجلس النواب.
|
احدث المنشورات

النشرة الشهرية كانون الثاني/يناير - من دافوس إلى الاستعراض الدوري الشامل: بين الالتزامات والمساءلة