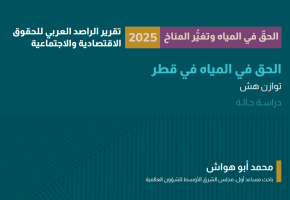مشاركة النساء في القوى العاملة في المنطقة العربية، قراءة نقدية في دور صندوق النقد الدولي – حسن شرّي

مشاركة النساء في القوى العاملة في المنطقة العربية، قراءة نقدية في دور صندوق النقد الدولي – حسن شرّي
"إذا استبعدتَ 50% من قاعدة المواهب، فلا عجب أن تجد نفسك في حربٍ من أجل استقطاب المواهب."
في السنوات الأخيرة، ورغم التحسّن الملحوظ في مستويات التحصيل التعليمي لدى النساء في المنطقة العربية، بقيت مشاركتهن في سوق العمل منخفضة بشكل لافت. فقد بلغ معدّل1 مشاركة النساء في القوى العاملة (FLFP) في المنطقة نحو 19٪ عام 2021،
مقارنة بمتوسّط عالمي يبلغ 47٪، ومعدّل 46٪ في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل. هذه الفجوة تعبّر عمّا يُعرف في الأدبيات بـ"مفارقة المساواة بين الجنسين" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: تقدّم كبير في التعليم يقابله ضعف شديد في النفاذ إلى سوق العمل.
يُطرح كثيرًا أن الأسباب دينية أو ثقافية، إلا أن البيانات المقارنة تُضعف هذا الادعاء. فبلدان مثل إندونيسيا وماليزيا وكازاخستان، وهي دول ذات غالبية مسلمة، سجّلت في عام 2021 معدّلات مشاركة نسائية تجاوزت المتوسط العالمي، وحتى متوسّط الاتحاد الأوروبي البالغ 51٪. وبالتالي، تُظهر التجارب الدولية أن الدين أو الثقافة ليسا تفسيرًا كافيًا.
لذلك، تُبرز الأدبيات الاقتصادية تفسيرات أكثر إقناعًا، من أبرزها نظرية تُعرف بـ "ثنائية سوق العمل 2". فالنساء في المنطقة العربية يمِلن تاريخيًا إلى تفضيل القطاع العام على القطاع الخاص، نظرًا لشروط العمل الأكثر ملاءمة ومزايا نظام التعويض السخية نسبيًا، بما في ذلك ساعات العمل المستقرة، الإجازات المدفوعة، مزايا رعاية الأطفال، التغطية الصحية، وخطط التقاعد. فعلى سبيل المثال، كان دخل النساء في القطاع العام في مصر أعلى بـ60٪ من القطاع الخاص في عام 1988 وبـ10٪ في عام 1998، وفي الأردن أعلى بنحو 17٪ (سعيد، 32013). نتيجة لذلك، لعب القطاع العام دورًا حاسمًا في استيعاب النساء المتعلمات، وأصبح بمثابة قناة رئيسية لانخراطهن في سوق العمل.
غير أنّ التحوّلات الاقتصادية منذ ثمانينيات القرن الماضي، وخصوصًا تصاعد "الثورة المضادّة الكلاسيكية الجديدة"، بوصفها ردًّا على صعود نظريات التبعية خلال الفترة الممتدة من الخمسينيات وحتى السبعينيات من القرن الماضي، وما رافقه من توسّع في برامج صندوق النقد الدولي في المنطقة، أدّت إلى تغييرات بنيوية عميقة. فقد رُبطت برامج الصندوق في العديد من الدول العربية بسياسات تقشفية تشمل تجميد التوظيف الحكومي، خفض فاتورة الأجور، وإعادة هيكلة القطاع العام.
هذا التقليص في قدرة الدولة على التوظيف أصاب بشكل مباشر القناة الأساسية لعمل النساء. فكانت النتيجة واضحة ومتوقّعة: انخفاض حاد في فرص العمل المتاحة للنساء، وانسحاب العديد منهن من سوق العمل تمامًا، بحيث يُصبحن محسوبات ضمن فئة خارج القوى العاملة (أي غير العاملات وغير الباحثات عن عمل). وتُعدّ مصر مثالًا لافتًا (ولو أنه ليس كافيًا وحده للحكم) إذ انخفض معدّل مشاركة المرأة في القوى العاملة من 23٪ عام 2016 إلى 16٪ عام 2019، وفقًا لقاعدة بيانات مؤشرات التنمية العالمية للبنك الدولي، وذلك في الفترة نفسها التي نُفِّذ فيها برنامج صندوق النقد الدولي.
ورغم أن الصندوق يؤكد في تقاريره أهمية إدماج النساء اقتصاديًا، تُظهر التجارب وجود فجوة بين الخطاب والسياسات الفعلية. إذ غالبًا ما ترتبط برامج الصندوق بإصلاحات مرونة سوق العمل التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار وزيادة التوظيف، لكنها قد تؤدي في الوقت نفسه إلى انتشار وظائف منخفضة الأجر وضعيفة الحماية، وهو ما يضر بالنساء اللواتي يتركزن أصلًا في الأعمال الهشّة وغير المستقرة، لا سيما في القطاع غير الرسمي.
ويتصل بذلك ملف الحماية الاجتماعية. فرغم دعم الصندوق لشبكات أمان اجتماعي تستهدف الفئات الأكثر هشاشة، إلا أنها غالبًا لا تصل إلى النساء العاملات في القطاع غير المنظم، أي للنساء اللواتي يمتلكن دخلًا منخفضاً ولكنهن غير مصنّفات ضمن الفئات الأشد فقرًا. كما أن هذه الشبكات لا توفّر لهن حماية من المخاطر اليومية المرتبطة بالعمل الهش. وهذا يثير سؤالًا حول مدى ملاءمة أدوات الحماية الحالية لطبيعة المخاطر الجندرية في أسواق العمل.
وتتأثر النساء أيضًا بسياسات تقليص العجز المالي وخفض الإنفاق العام، خصوصًا في قطاعات التعليم والصحة والرعاية. فالنساء يعتمدن بشكل أكبر على الخدمات العامة، وضعف هذه الخدمات يدفعهن لتحمّل عبء إضافي من العمل غير المدفوع داخل المنزل، ما يحد من قدرتهن على دخول سوق العمل أو الاستمرار فيه. ومن هنا تظهر معضلة أساسية: كيف يمكن تحقيق استقرار مالي دون الإضرار بالخدمات التي تشكّل رافعة أساسية لتمكين النساء اقتصاديًا؟
أما السياسات النقدية، فهي بدورها تطرح إشكاليات إضافية. إذ إن الاعتماد على رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم قد يحد من الاستثمار والنشاط الاقتصادي، الأمر الذي يؤثر بوضوح على النساء العاملات في المشروعات الصغيرة أو الأنشطة المنزلية. وفي فترات التباطؤ الاقتصادي، ينخفض الطلب وتتراجع المداخيل، وهو ما يعرّض النساء للأزمات بشكل أكبر.
لا تهدف هذه القراءة إلى تحميل صندوق النقد الدولي مسؤولية ضعف مشاركة المرأة، إذ أنّ جزءًا كبيرًا من التحدي يعود إلى اختلالات بنيوية وهيكلية في اقتصادات المنطقة، بما في ذلك هشاشة الهياكل الاقتصادية وضعف القواعد الإنتاجية، والاعتماد على الريع أو على مصادر تمويل خارجية غير مستقرة، إلى جانب الميل المرتفع نحو الاستيراد، فضلاً عن غياب الإنصاف في النظام المالي العالمي. لكنّها تُبرز الحاجة إلى مواءمة السياسات الاقتصادية مع واقع النساء، عبر تعزيز الحماية الاجتماعية الشاملة، الاستثمار في خدمات الرعاية، وضمان أن إصلاحات سوق العمل لا تزيد من هشاشة أو إقصاء النساء، بل تفتح أمامهن فرصًا حقيقية للاندماج الاقتصادي.
المراجع
1البنك الدولي، مؤشرات التنمية العالمية. (2023). معدلات مشاركة الإناث في القوى العاملة.
2أسعد، ر. (2019). التوظيف العام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. IZA عالم العمل.
سعيد، م. (2014). تكوين الأجور وعدم المساواة في الدخل في سوق العمل الأردني. سوق العمل الأردني في الألفية الجديدة، 144-3171.
احدث المنشورات

النشرة الشهرية كانون الثاني/يناير - من دافوس إلى الاستعراض الدوري الشامل: بين الالتزامات والمساءلة