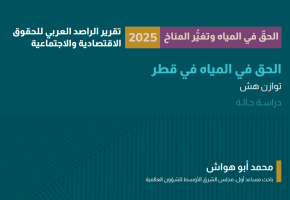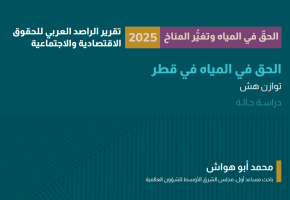أزمة ديون لبنان: كارثة من صنع الإنسان ومسار التعافي - د. خليل جبارة
يواجه لبنان انهيارًا اقتصاديًا وماليًا يُعتبر عالميًا من أشد الانهيارات منذ منتصف القرن التاسع عشر. منذ عام ٢٠١٩، انكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد بنحو ٤٠٪، وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من ٩٨٪ من قيمتها مقابل الدولار، وسقط أكثر من نصف السكان في براثن الفقر. لم يكن تخلف الحكومة عن سداد ديونها المستحقة على سندات اليوروبوند في مارس ٢٠٢٠ - وهو أول تخلف سيادي للبنان في التاريخ - صدمةً مفاجئة، بل كان نتيجةً حتميةً لعقود من الإخفاقات السياسية المنهجية.
يُحلل تقريري الأخير، "الاقتصاد السياسي لتراكم الديون في لبنان"، الذي أعددته لشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، المشكلات الهيكلية العميقة التي أدت إلى هذه الأزمة، ويرسم مسارًا شاملًا نحو التعافي المستدام.
الأسباب الجذرية لدوامة الديون في لبنان
تنبع أزمة ديون لبنان من ثلاثة إخفاقات مترابطة تفاقمت على مدى ما يقرب من ثلاثة عقود.
1. نموذج اقتصادي معيب أساساً
تكمن جذور أزمة الديون السيادية في لبنان في خيارات السياسات والنموذج الاقتصادي المُعتمد بعد انتهاء الحرب الأهلية. خلال تسعينيات القرن الماضي، شرعت البلاد في برنامج إعادة إعمار طموح، مُوِّل بشكل رئيسي من خلال الاقتراض المكثف. أدى هذا النهج إلى عجز هائل في الميزانية وتراكم سريع للدين العام. بين عامي 1992 و1997، بلغ متوسط العجز المالي حوالي 20.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مع عجز أولي بلغ حوالي 10.7%. في هذه الفترة، ارتفع الدين العام من 2.9 مليار دولار إلى 16.5 مليار دولار، متجاوزًا 100% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 1997.
أدى هذا النموذج إلى اعتماد هيكلي على تدفقات رأس المال الأجنبي لتمويل عجزين مزمنين - عجزي المالية والحساب الجاري. بحلول عام 2019، تجاوز عجز الحساب الجاري في لبنان 20% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو من بين أعلى المعدلات عالميًا، بينما استوردت البلاد أكثر من 80% من احتياجاتها الاستهلاكية. أصبح الاقتصاد آلة استهلاكية مدعومة بالتمويل الخارجي بدلاً من الاستثمار الإنتاجي.
2. سوء الإدارة المالي والنقدي الكارثي
اتسمت إخفاقات السياسة المالية بالمنهجية والمستمرة. سيطر الإنفاق العام على نفقات جامدة: رواتب القطاع العام، وخدمة الدين، والدعم الحكومي الضخم، لا سيما لتغطية عجز شركة كهرباء لبنان، الذي استهلك أكثر من 75% من الميزانية. امتصت هذه الإعانات وحدها ما بين 3 و4% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا، أي أكثر من إجمالي الإنفاق على الصحة والتعليم.
اتسم تحصيل الإيرادات بعدم الكفاءة والتراجع الشديد، حيث اعتمد بشكل كبير على الضرائب غير المباشرة مثل ضريبة القيمة المضافة، بينما عانى من التهرب الضريبي على نطاق واسع. وكان الانهيار التام للحوكمة المالية هو الأشد ضررًا: فقد عمل لبنان بدون ميزانية رسمية لأكثر من عقد (2005-2016)، معتمدًا بدلًا من ذلك على الإنفاق من خارج الميزانية الذي قضى على أي تظاهر بالتخطيط المالي أو المساءلة.
وفاقمت السياسة النقدية هذه المشاكل. وقد وفّر قرار عام 1997 بربط الليرة اللبنانية بالدولار الأمريكي عند 1507.5 ليرة لبنانية استقرارًا في البداية، لكنه أصبح غير مستدام بشكل متزايد. للدفاع عن تثبيت سعر الصرف، عرض مصرف لبنان أسعار فائدة مرتفعة بشكل مصطنع لجذب الودائع الدولارية. وعندما تباطأت تدفقات رأس المال بعد عام ٢٠١١ بسبب عدم الاستقرار الإقليمي، لجأ مصرف لبنان إلى عمليات "هندسة مالية" أشبه بمخطط بونزي، إذ تطلبت ودائع جديدة متزايدة باستمرار لسداد الالتزامات القائمة، مع تراكم خسائر خفية هائلة تُقدر بما بين ٥٠ و٦٠ مليار دولار.
3. الانهيار المؤسسي وإخفاقات الحوكمة
تكمن وراء هذه التشوهات الاقتصادية منظومة حوكمة معطلة للغاية، متجذرة في ترتيبات تقاسم السلطة الطائفية. وقد سيطرت النخب السياسية بشكل منهجي على مؤسسات الدولة، وعاملت الوزارات والهيئات العامة كغنائم سياسية بدلًا من أن تكون أدوات للخدمة العامة. وقد حال هذا دون وضع استراتيجيات تنمية وطنية متماسكة، مع عرقلة الإصلاحات الأساسية في كل خطوة.
أصبحت مؤسسات الرقابة الرئيسية - ديوان المحاسبة، وهيئة التفتيش المركزي، ومجلس الخدمة المدنية - غير فعالة بسبب التدخل السياسي ونقص الموارد. ويُصنف لبنان من بين أسوأ البلدان عالميًا في مؤشرات الشفافية والحوكمة، حيث يعتقد أكثر من 85% من المواطنين أن الفساد منتشر في المؤسسات العامة، وفقًا لاستطلاعات حديثة.
استراتيجية شاملة للتعافي
يتطلب التصدي لهذه الأزمة تجاوز الإجراءات الجزئية نحو إطار إصلاحي متكامل قائم على خمس ركائز أساسية.
إعادة بناء مصداقية المالية العامة
يبدأ التعافي بوضع أطر مالية موثوقة، ترتكز على ميزانيات واقعية مع توقعات شفافة للإيرادات والنفقات. ويتطلب ذلك إصلاحًا ضريبيًا شاملًا لتعزيز تعبئة الإيرادات المحلية مع تقليل الاعتماد على الضرائب غير المباشرة التنازلية. وتُعدّ ممارسات الإدارة المالية العامة الحديثة - ربط الإنفاق بالتدفقات النقدية، وتطبيق قوانين المشتريات، وإلغاء النفقات خارج الميزانية - أساسية لإعادة بناء ثقة الجمهور.
إعادة هيكلة شاملة للقطاع المالي
تتطلب الأزمة المصرفية حلاً شفافًا وعادلاً يُعالج الترابط بين الميزانيات العمومية للجهات السيادية والبنك المركزي والبنوك التجارية. ويتمثل أحد التعقيدات الحرجة في أن المؤسسات المحلية استحوذت على ما يقرب من 37% من ديون سندات اليوروبوند "الأجنبية" للبنان اعتبارًا من عام 2019، مما يُطمس الفروق التقليدية بين الدائنين المحليين والخارجيين. يجب أن تُعالج إعادة هيكلة الديون حاملي السندات الخارجيين والمؤسسات المالية المحلية في آنٍ واحد، مع ضمان تقاسم عادل للأعباء يحمي صغار المودعين.
تعزيز الحماية الاجتماعية
لا يُمكن للإصلاح الاقتصادي أن يُثقل كاهل الفئات الأكثر ضعفًا بشكل غير متناسب. يجب على لبنان توسيع نطاق برامج التحويلات النقدية المُستهدفة للفقر، مع الحفاظ على الإنفاق العام الأساسي على الصحة والتعليم والأمن الغذائي. يجب أن تشمل إصلاحات الدعم آليات تعويض للفئات الأكثر ضعفًا لمنع تعميق عدم المساواة خلال فترة الإصلاح.
إنعاش القطاعات الإنتاجية
يجب على لبنان الانتقال من تنمية قائمة على الاستهلاك إلى تنمية قائمة على التصدير. يتطلب ذلك تبسيط الإجراءات البيروقراطية، وتقليص العوائق التنظيمية، وتوسيع نطاق الحصول على التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاعات الزراعة والتصنيع والتكنولوجيا. يُعدّ إشراك المغتربين اللبنانيين في الاستثمار الإنتاجي - بدلاً من تدفقات المضاربة - أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق انتعاش مستدام.
الإصلاح المؤسسي واستعادة الحوكمة
يتطلب التعافي المستدام إصلاحًا مؤسسيًا عميقًا لاستعادة شرعية الدولة. ويشمل ذلك تنفيذ إصلاحات قضائية وإدارية تضمن المساءلة وتحد من التدخل السياسي. ويجب إنفاذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد من خلال هيئات رقابية مستقلة ومتمكنة تتمتع بالموارد الكافية والسلطة القانونية.
الاقتصاد السياسي للديون: استراتيجية بقاء النظام
تم تمويل إعادة إعمار ما بعد الحرب في التسعينيات عمدًا من خلال الاقتراض بدلًا من الضرائب، مما سمح للنخب السياسية بتوزيع غنائم إعادة الإعمار عبر شبكاتها.
استمر هذا السلوك بعد الجمود السياسي المطول الذي أعقب عام 2005، عندما أصرت النخبة السياسية على الاقتراض للحفاظ على شبكات المحسوبية. إلا أن مشكلة هذا النهج تكمن في أن الطريق لم يكن مستقيمًا، بل كان منحدرًا حادًا نحو الانحدار. فكل تأخير زاد من حدة الانهيار النهائي، وتطلبت كل خطة هندسة مالية مبالغ مالية متزايدة للاستمرار. وقد واكبت النخبة المصرفية هذا الوضع، معطية الأولوية للأرباح قصيرة الأجل على حساب استدامة القطاع المصرفي. وبحلول عام 2019، عندما انهار النظام أخيرًا، أصبحت التشوهات المتراكمة هائلة لدرجة أنها دمرت المجتمع اللبناني.
لم يغير انهيار عام 2019 تفضيلات النخبة السياسية. ظلّ الحفاظ على شبكاتهم الزبائنية هدفهم الأسمى، متجاوزًا أي اهتمام بحماية أموال المودعين أو منع شريحة كبيرة من الشعب اللبناني من الوقوع في براثن الفقر. وبدلاً من ذلك، اختاروا الحفاظ على مصالحهم من خلال استغلال الاحتياطيات الإلزامية وما تبقى من أموال المودعين. وللأسف، أظهرت نتائج الانتخابات النيابية لعام ٢٠٢٢ نجاح استراتيجيتهم.
في الختام، تُمثّل أزمة ديون لبنان الفشلَ النهائي لاقتصاد سياسي صُمّم لخدمة مصالح النخبة بدلًا من التنمية الوطنية. لا يتطلب التعافي إصلاحات اقتصادية تقنية يقودها وزراء تكنوقراط فحسب، بل يتطلب أيضًا تحولًا جذريًا في النظام السياسي الذي تسبب في هذه الكارثة التي صنعها الإنسان.