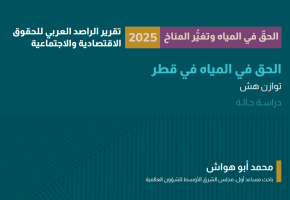Feb 18, 2025
عن عقد اجتماعي جديد في عالم متوحش - اديب نعمه
اديب نعمه
خبير ومستشار في التنمية والسياسات الاجتماعية ومكافحة الفقر
الرجاء الضغط هنا
لنبذة والمنشورات

عن عقد اجتماعي جديد في عالم متوحش - اديب نعمه
سياق
شاركت
يوم 12 شباط/فبراير 2025 في مؤتمر افتراضي نظمته منظمة العمل الدولية حول
"العقد الاجتماعي الجديد في الشرق الأوسط وشمال افريقيا"، مع التركيز
على حقوق العمال وتوفير فرص العمل اللائق للجميع في ظل الازمات المتعددة التي
تجتاح العالم ومنطقتنا. كانت الجلسة التي شاركت فيها تتعلق بالجواب على سؤال يطلب
تحديد "العوامل الأكثر اهمية التي تعيق بناء اقتصادات توفر فرص العمل اللائق
للجميع، وارتباط ذلك بإطار الاقتصاد الكلي والأزمات المتعددة".
فيما يلي بعض الأفكار والخواطر
التي اثارتها هذه المشاركة في هذا المؤتمر.
مشهد افتتاحي
تنزاح الستارة عن مكتب الرئيس دونالد ترامب،
وعن يمينه السيد إيلون ماسك، وصحفي. يسأل الصحفي "ما رأيك سيادة الرئيس بفكرة
العقد الاجتماعي؟" يأتي الجواب سريعا: "هذه فكرة قديمة جدا لا علاقة لها
بالعصر. لا اعرف تماما من اخترع هذه الفكرة ومتى، لكنها على الأرجح أتتنا من
العالم القديم (أوروبا) منذ مئات السنين (طبعا لا نتوقع منه ان يعرف عن عصر
الانوار ومفكريه الذين ساهموا في بلورة هذه الفكرة مثل روسو، وهوبز، ولوك وغيرهم)
...لا بل لا افهم تماما ما معنى أن يكون أي عقد اجتماعيا! فأنا لم اسمع بمثل هذه
النوع من العقود". ويضيف: "ربما كان هذا امرا من اختراع جماعة يسارية او
بيئية متطرفة تريد تقويض حرية رأس المال، والدور القيادي لأميركا العظيمة في قيادة
الاقتصاد العالمي".
انتهى المشهد.
العقد الاجتماعي
الصيغة المستجدة من "العولمة المتوحشة" التي بدأت ترتسم معالمها
بوضوح مع وصول دونالد ترامب الى البيت الأبيض والاحتفاء الحماسي بذلك من قبل اليمين
المتطرف العالمي، تشكل نقضا كاملا لفكرة "العقد الاجتماعي" وفلسفتها.
فمثل هذه الأفكار المتولدة في "عصر الانوار"، هي في نظر أنصار العولمة
النيوليبرالية المتوحشة بمثابة كائنات منقرضة و"أعشاب ضارة" يجب ازالتها
لأنها تضر بالنمو الاقتصادي، وتعيق الاندفاع الكامل لقيم المنفعة المتفلتة من أي
قيد، التي تدفعها المنظومة العولمية المتوحشة المستجدة الى حدودها القصوى. على هذا
الأساس فإن المعركة من اجل عقد اجتماعي جديد هي معركة عالمية تهدف إلى منع استئصال
هذه الفكرة نفسها من نسق العلاقات الاقتصادية والمجتمعية. وهي بهذا المعنى تتعلق بجوهر
منظومة القيم والخيارات العنصرية والعنفية التي تحتقر الحقوق كلها، ما عدا حق
أصحاب السلطة والمال المتربعين على قمة الهرم الاقتصادي والسياسي، في تعظيم الربح والسيطرة
على العالم. فلا مكان لعقد اجتماعي بين أطراف مجتمعية يقوم على الندية وعلى
الاعتراف بالحق المتبادل في الدفاع عن المصالح المتباينة او المتعارضة، بالتلازم
مع العمل على التوصل الى تسويات تاريخية متحركة بين هذه المصالح.
غالبا ما يجري التركيز على العقد الاجتماعي باعتباره عقدا بين الحكومات (أو
السلطة) والمواطنين. هذا صحيح، إلا انه لا يكون كذلك الى في لحظة تالية للعقد
الفعلي الذي يتشكل من خلال الصراع/النضال/التفاوض بين المكونات الاجتماعية،
وتعبيراتها السياسية والنقابية والمجتمعية في قاعدة المجتمع نفسه، ثم يتحول في
اللحظة التالية الى إطار علائقي مكتوب (دستور) ممأسس في أنظمة سياسية، تنبثق عنه
سياسات تسعى الى ترجمة مبادئ وتوجهات العقد والالتزامات المتبادلة الواردة فيه الى
واقع فعلي. ولا يكون ذلك في لحظة واحدة ونهائية، بل هو مسار ديناميكي من الصراع
والتوازنات المتحركة بين المصالح والخيارات لمختلف التكوينات الاجتماعية.
كما هي الحال دائما، هناك عوائق مصدرها الأساسي هو الدول الوطنية نفسها
وسياساتها، مع تأثيرات إقليمية. وهناك عوامل أخرى مصدرها العولمة والسياسات التي
تحدد ملامح وتوجهات الاقتصاد العالمي، الذي يشكل بدوره عاملا حاسما ومقررا في
السياسات الإقليمية والوطنية. وفي هذه اللحظة التاريخية تحديدا، فإن السياقات
العالمية هي المحددة والأكثر أهمية، وهي التي تشكل العقبة الرئيسية التي امام
التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلداننا، ومن ضمنها توفير فرص العمل اللائق
للجميع. لا يعني ذلك بأي شكل من الاشكال، اعفاء الحكومات الوطنية وسياساتها والقوى
الاجتماعية والاقتصادية التي تقف خلفها من المسؤولية، لا بل ان الاستسلام التبعي
للتوجهات العالمية يعظّم مسؤوليتها بدل ان ينتقص منها.
يكمن السبب الجذري والعميق لتعذر بناء اقتصاد عادل وتضميني يحقق التوظيف
اللائق للجميع في ان تحقيق هذه الهدف يتطلب منهجا وخيارات وحاملا اجتماعيا –
تاريخيا تذهب كلها في الاتجاه المعاكس تماما لتوجهات العولمة النيوليبرالية
السائدة منذ الثمانينات؛ وهي على تضاد كلي أكثر حدة مع التوجهات العولمية المستجدة
التي يقود التحول باتجاهها اليمين العالمي المتطرف بقيادة الرئيس الأميركي ترامب.
وتتميز هذه الصيغة المستجدة بعودة الميول الحمائية والحروب التجارية بين اقطاب
العولمة الحاليين (بمن فيهم وعلى رأسهم الصين في الزمن الحالي)، كما تتميز بالعنف
والتوحش والنزعة الكولونيالية والخروج الكامل على منظومة الحوكمة العالمية التي
تشكلت بعد الحرب العالمية الثانية. ولعل ما شهده العالم خلال السنوات الأخيرة، بما
في ذلك منطقتنا العربية، وما حصل من حرب إبادة في فلسطين – غزة تحديدا والضفة
الغربية – وامتداد الى لبنان ومجمل المنطقة عام 2024، شاهد صارخ على مثل هذا
التحول (دون اغفال ما يحدث في أماكن أخرى من العالم، بما في ذلك داخل دول المركز
الرأسمالي نفسه).
يطرح هذا التحول تحديات واشكاليات أساسية اذ لم يعد بالإمكان مواجهة هذه الخيارات
ونتائجها بالتمسك بالاستراتيجيات السابقة والبقاء ضمن السقوف المؤسسية السائدة.
ذلك لم يعد كافيا، وفي بعض الحالات لم يعد فعالا وملائما؛ فلا بد البحث عن
استراتيجيات مواجهة بديلة وفعالة قادرة على كبح جموح التوحش الكولونيالي
والنيوليبرالي في صيغته المستجدة كي نكون قادرين على الدفع باتجاه تغيير الواقع
الحالي والتصدي للأزمات التي يولدها، وتجاوز هذه الازمات بنجاح او بأقل قدر من
الخسائر على الأقل.
يصنعّون الازمة ويصممون الاستجابة لها!
قادة العولمة يصنعّون الازمات بسياساتهم وخيارتاهم؛ الا انهم لا يكتفون
بذلك بل يعملون على استباق أي استجابة لهذه الازمات يمكن ان تصاغ من موقع نقيض او
بديل، وهو ما يشكل فعل احتواء لا بل مصادرة للبدائل الممكنة. يتم ذلك بشكل خاص من
خلال إغراق البحث والنقاش الدائر في صدد الحلول الممكنة للأزمات التي ينوء عالمنا
المعاصر تحت ثقلها، بمقاربات وأفكار وحلول من صنعهم تتميز بطابعها التقني الذي
يراد به الإيحاء بالحياد والاستناد الى العلم. يساعدهم في ذلك تحكمهم بالمؤسسات
المنتجة والناشرة للأفكار والايديولوجيات المروجة للعولمة النيوليبرالية. كما
يساعدهم أيضا انهم صنعوا سردية بعينها عن النمو الاقتصادي والحوكمة وأسباب الازمات
على امتداد العقود الممتدة منذ مطلع الثمانينات، يتعامل كثير من الأطراف معها
كأنها بديهيات لا شك فيها.
بعض من يتناول مشكلات الاقتصاد والعمل (اللائق) في بلداننا (النامية) ينسب
السبب الى قصور او فشل في منظومة الحوكمة الاقتصادية او حوكمة سوق العمل. تحال
الحوكمة هنا الى إجراءات تقنية بالدرجة الأولى بعيدا عن مكونها السياسي؛ فلا يقصد
بها الاستبداد وغياب الديمقراطية مثلا، بل يقصد بها: التأخر في اعتماد او استخدام
التقنيات؛ او تخلف البنية التحتية والتجهيزات المناسبة للتحول الرقمي؛ او البقاء
على هامش الثورات العلمية والتكنولوجيا بما في ذلك التأخر في الدخول في العصر
الرقمي والذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة او الخامسة...الخ؛ الى ما
هنالك من مفردات ومصطلحات جذابة. ويشار غالبا الى التفاوت القائم بين سرعة
التحولات العالمية في سوق العمل، وبين بطء التحولات في حوكمة الاقتصاد وسوق العمل
في بلداننا، وهو ما يحيل الى ضرورة تسريع تغيير منظومة القوانين والقواعد الناظمة
للاقتصاد والعمل وسوق العمل في البلدان النامية للاستجابة للتحولات العالمية. بقدر
ما يبدو هذا الاستنتاج بسيطا ومباشرا، لا بل بديهيا، فإن مثل هذه الطروحات تقتصر
على التحديث الإداري والتقني، والمكننة والرقمنة...الخ، دون أي إشارة صريحة الى
المضمون السياساتي والحقوقي لمثل هذه الإصلاحات او التغييرات المطلوبة، الامر الذي
يعني القبول بكل الحزمة المعولمة التي تتضمن انحيازات خطيرة لصالح رأس المال على
حساب العمل.
تغفل هذه الطروحات تحديد ملامح وشروط "العقد الاجتماعي" العام،
وذاك الخاص بالعلاقة بين العمال وارباب العمل والدولة، او بين العمل ورأس المال،
على المستويين العالمي والوطني. وما يعنيه الكلام عن "مرونة" سوق العمل
في الخطاب النيولبيرالي هو تفكيك القوانين والقواعد الناظمة للعلاقة بين العمال
والاجراء وأصحاب العمل، كما حدث فعليا خلال العقود السابقة والذي أدى الى: اضعاف
القوة التفاوضية للنقابات؛ وتحرير عقود العمل من القوانين التي تحمي الوظائف
والاجراء؛ والتوسع الكبير جدا في العمل غير النظامي؛ وانتهاك الالتزام بالحد الأدنى
للأجور الذي يضمن العيش اللائق؛ والتخلي عن فكرة أنظمة الحماية الاجتماعية الشاملة؛
والاستمرار في عدم تقييم العمل الرعائي...الخ. كل ذلك يندرج في سياق تفكيك
"دولة الرعاية" والمسؤولية الاجتماعية والبيئية للدولة، وتحرير الأسواق
وحرية رأس المال مع تقييد حرية انتقال القوى العاملة، على الرغم من تحول العمال
المهاجرين الى قوة منتجة بالغة الاهمية في كل البلدان، وهي تتعرض لاستغلال مضاعف
لاسيما في بلداننا.
بهذا المعنى عندما يتم الحديث عن ضرورة تطوير حوكمة الاقتصاد وسوق العمل،
لاسيما في بلداننا، فإن الاولوية هي حتما لجعل "العقد الاجتماعي" الناظم
بين العمال واصحاب العمل، او بين العمل ورأس المال، أكثر التزاما بالعدالة ومنظومة
الحقوق، ويوفر حماية اكثر فعالية لحقوق العاملين بالمعنى الواسع بما يتوافق مع
تعدد اشكال العمل، والتحولات التي طرأت على سوق العمل، بدءا من العمال المهاجرين
العاملين في الاعمال الصعبة والهامشية، وصولا الى العاملين في اقتصاد المنصات.
وبهذا المعنى أيضا فإن المقصود بالمرونة غالبا يكون تفكيك القواعد الناظمة للعمل
وحماية العمال deregulation، وهي ثالث أقانيم الثالوث
النيوليبرالي منذ بداية الثمانيات الى جانب التحرير الاقتصادي والخصخصة. إن الوجهة
المطلوبة للتطوير هي وجهة الحقوق المعاكسة تماما للإيغال في تعميق الهوة بين العمل
ورأس المال لصالح الاخير، كما تتضمنه فعليا دعوات الحوكمة الرشيدة النيوليبرالية
المستجدة.
فكرة أخيرة في هذا السياق يتعلق بالذكاء الاصطناعي وأثره على العمل وسوق
العمل والاقتصاد في بلداننا. ما من شك ان التطوير التكنولوجي والرقمنة والذكاء
الاصطناعي (بغض النظر عن تعريف هذه الأخير وتسميته) تؤثر مباشرة في سوق العمل وفي
تنظيمه وتحديد خصائصه. ويتوقع في السنوات والعقود القادمة ان تنشأ ووظائف جديدة،
وان تختفي أخرى، لاسيما في بعض القطاعات التقليدية التي توفر التكنولوجيات الحديثة
بدائل حقيقية وقليلة الكلفة لها، او في بعض القطاعات الاقتصادية الطليعية التي
ستكون أكثر تأثرا بالرقمنة والذكاء الاصطناعي، وفي القطاعات الخدماتية.
من الطبيعي ان تكون دول المركز الرأسمالي، وبعض قطاعاتها أكثر تأثرا بذلك
من البلدان النامية مثلا. لذلك فإن مجرد استنساخ هذا الخطاب من قبل بعض المسؤولين
او أصحاب الاعمال او المعنيين الآخرين بالعمل في بلداننا، لا يأخذ بعين الاعتبار
خصائص ومشكلات بلداننا واقتصاداتنا، وخصائص العمل وسوق العمل فيها. يكفي ان نشير
مثلا الى بعض الدعوات التي تتردد كالصدى هنا وهناك الى ضرورة الدخول في الثورة
الصناعية الرابعة او الخامسة في بلدان بالكاد أنجزت الثورة الزراعية او الصناعية
الأولى. كما ان تأثير الرقمنة والذكاء الاصطناعي في بلدان نسبة العمل غير النظامي
فيها تتراوح بين 60% و70% مثلا، وفي قطاعات قليلة الإنتاجية، مع بنى تحتية رقمية
متخلفة ومستوى تعليمي منخفض وغير ملائم لجهة النوعية والجودة...الخ، لا يمكن ان
يكون مشابها لأثر الرقمنة والذكاء الاصطناعي في البلدان التي انتجت فيها هذه
التكنولوجيات وحيث تستخدم على نطاق واسع ومؤثر في الإنتاج وفي إدارة المجتمع؛
وعلينا ان نبحث جديا في اثرها في بلداننا بعيدا عن الاسقاط والاستنساخ الساذج.
Polycrisis
الترجمة الأقرب الى هذه المصطلح الجديد الذي
دخل الخطاب العالمي هو "ازمة واحدة في أزمات"، او "أزمات متعددة في
ازمة واحدة". هو ليس تعدد لأزمات متراصفة ومتجاورة يعاني منها عالمنا
المعاصر، مثل ازمة التغير المناخي، والأزمات الاقتصادية، والتوترات
الجيوسياسية...الخ. لكنه في استخدامه الشائع لا يزال مفهوما قاصرا لأنه يعتبر ان
الازمات الراهنة تولدت بشكل متواز في نواحي الحياة وفي العالم، وأثّر تزامنها في
لبّ النظام العالمي الذي تحكمه النيوليبرالية. أي ان فعل الأزمة/الازمات هو من
الخارج الى الداخل، ومن أطراف النظام الى مركزه، ومن تعدد الازمات المتعين في
القطاعات والمجالات المختلفة الى قلب العولمة النيوليبرالية واقتصادها الكلي.
هذه مقاربة جزئية وقاصرة. إذا كان مسار التأزم من الخارج الى الداخل صحيحا،
الا ان الدينامية الأكثر أهمية وتأثيرا، أي الدينامية الغالبة والمهيمنة، هي تلك التي
تنطلق من مركز النظام ومن نواته الصلبة – أي الاقتصاد الكلي النيوليبرالي – الى
التجليات المتعددة وليس العكس. فهذه الازمات المتعددة (مناخ، ركود، حرب، تهميش،
لامساواة...الخ)، هي بالدرجة الأولى تجليات وتمظهرات ونتائج متولدة عن الازمة
الهيكلية للنموذج النيوليبرالي المعولم المهمين منذ بداية الثمانينات، ومن نموذج
اقتصاده الكلي تحديدا. فقد بلغ هذا النموذج حدّه التاريخي وبات تجاوزه امرا ضروريا
وملحا لإنقاذ الكوكب والناس والشعوب من الكوارث المحدقة بهم، بدءا من التغّير
المناخي، الى الركود الاقتصادي والتحول الى اقتصاد وهمي، وصولا الى حرب الإبادة،
والى تعميم التفاهة وتدمير منظومة القيم والمعايير التي تعبّر عنها منظومة حقوق
الانسان، والآليات الدولية المولجة بإنفاذها من منظمة الأمم المتحدة وصولا الى
مجمل الآليات والمؤسسات العالمية الأخرى.
ان التصور الحالي للخيارات الاقتصادية والاجتماعية الكلية التي تتشكل
وتتوسع على يد اليمين العالمي المتطرف ردا على ازمة نموذج العولمة النيوليبرالية
السائد منذ الثمانينيات، تتضمن التحول عن بعض الخيارات والسياسات السابقة والعودة
الى الحمائية القومية، والتعصب، والحروب التجارية، استخدام الحرب بلد الوسائل
الديبلوماسية في العلاقات الدولية، وتفكيك النظام الدولي الذي تشكل بعد الحرب
العالمية الثانية. كل ذلك يدفع الى خلق وضع عالمي يشبه ما كان قائما قبل الحرب
العالمية الأولى (والثانية)، مع ما يرافقه من فوضى عالمية، ونزعة استعمارية –
كولونيالية عنيفة ومتوحشة. ومثل هذا الوضع يدفع العالم قسرا الى الكارثة الكونية
بقوة مصالح الـ 1% الذين يحتكرون المال والسلطة والعنف والاعلام، وبقيادة اليمين
العالمي المتطرف وعلى رأسه الرئيس الأميركي الجديد.
هل المواجهة ممكنة؟
طبعا؛ واحتمالات النجاح فيها مرجّحة لا بل اكيدة. الا ان المسألة المطروحة
هي كيف نقلل الثمن الذي سيدفعه الكوكب والعالم وشعوبه، قبل وضع حد لهذا الجنون
الوحشي والعودة الى مسارات عالمية تتضمن الحد الضروري من الالتزام بمنظومة حقوق
الانسان، وهدف الحفاظ على السلم العالمي ووقف مسار تدمير الكوكب.
جانب أساسي من النجاح يتوقف على توفر القناعة العامة عالميا ووطنيا بأن المعالجات
الجزئية والجانبية التي تقتصر على النتائج، لا على الأسباب والديناميات المولدة
للأزمات، لم تعد كافية وهي هدر للوقت والجهد. لا بد من اعلان فشل نموذج العولمة
النيوليبرالية السائد منذ الثمانينات، لكن لا من اجل فرض نماذج جديدة أكثر توحشا
كما يريد اليمين العالمي المتطرف ونزعته الكولونيالية والعنصرية التي نشهدها
حاليا. ففشل هذا النموذج وصيغته المستجدة الاكثر توحشا وتفاهة، يعني التوجه نحو
نموذج بديل يعيد الاعتبار الى منظومة حقوق الانسان وقيمها ومعاييرها ومن ضمنها
الحق في التنمية وتقرير المصير، والى الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة،
وحماية كوكبنا - بيتنا المشترك من التدمير الممنهج بحكم أنماط الإنتاج والاستهلاك
غير المستدامة. هذه القناعة المزدوجة بـ:
أ-
فشل النموذج النيوليبرالية بسبب طبيعته
ومآلاته الأكثر توحشا،
ب-
وضرورة التوجه نحو بديل يلتزم حقوق الانسان
والعدالة والديمقراطية وحماية الكوكب وشعوبه؛
اديب نعمه
summary_large_image
احدث المنشورات
Feb 07, 2026

النشرة الشهرية كانون الثاني/يناير - من دافوس إلى الاستعراض الدوري الشامل: بين الالتزامات والمساءلة
Feb 06, 2026