
انتخابات 6 أكتوبر: حملة باهتة ونتيجة محسومة سلفا - محي الدين لاغة
انتخابات 6 أكتوبر: حملة باهتة ونتيجة محسومة سلفا - محي الدين لاغة
كما كان متوقّعا، فازَ الرّئيس المُنْتهيَةُ وِلايتَه قيس سعيد بولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 6 أكتوبر 2024، وحصل على 90 بالمائة من الأصوات وهي نسبة خُيل للتونسيين أنّها باتتْ من الماضي بعد ثورة 2010. لكنّ كلّ المتتبّعين للشأن السياسي في تونس يُدركون أنّ هذه النسبة لا تعكس غير اختيار 28 بالمائة من المُسجّلِين في اللّوائح الانتخابية (2,4 من جملة 9,7 مليون)، وأنّها أدنى نسبة سُجلت في تاريخ الانتخابات التونسية، وأنّ قرابة ثلاثة أرباع الناخبين قاطعوها (بخلفية سياسية او بدونها)، فضلا عن مؤشر آخر مُهمّ يتمثلُ في أنّ قرابة 94 بالمائة من الشباب لم يُدلوا بأصواتهم فيها.
وبقطع النظر عن الزاوية التي يُنظر من خلالها إلى تلك النسب وأبعادها مُستقبلاً على البلاد فقد كانت مُنتظرةً من قِبل مختلف مكونات المجتمع المدني في تونس بما أنها كانت تتويجًا لمَسار سياسيّ منذ جويلية 2021، سيْطرَ فيه الرئيس قيس سعيد تدريجيا على كلّ السّلط، التي تحوّلت إلى وَسَائطَ مَهّدتْ السّبيل لتأتيَ الانتخاباتُ الأخيرةُ مُجرّد مُنعرجٍ لِبيْعتِه لولاية جديدةٍ.
فبعد حلّ البرلمان التعدّدي المنتخب سنة 2019 وإيقاف العمل بدستور ما بعد الثورة (سنة 2014)، أصدر الرئيس في مرحلة أولى مرسوما جعل من الرئاسة المصدر الوحيد غير القابل للمراجعة في سنّ المراسيم والقوانين (مرسوم 117 لسنة 2021)، ثم فرض دستورا جديدا (25 جويلية 2022) حدّد تنظيما سياسيا عموديا تحوّلت فيه السلطة القضائية إلى مجرد وظيفة وباتت فيه السلطة التشريعية (المُوزّعة على مجلسيْن) بدون نفوذ فعلي في مراقبة السلطة التنفيذية.
ضمن هذا السياق جاء المسار الانتخابي غير مستوف لشروط الانتخابات النزيهة والشفافة لا من الناحية الواقعية ولا القانونية: فقد رفع الدستور الذي صاغه الرئيس بنفسه ولم ينل ثقة الغالبية الساحقة من التونسيين سنة 2022، سنّ الترشح من 35 إلى 40 سنة، ومنعَ التونسيين مُزْدَوجِي الجنسيّة من الترشح، كما أقر ضرورة تقديم البطاقة التي تثبت تمتّع المواطن بحقوقه المدنية (البطاقة عدد 3) بشكل مسبق (رغم إسقاط المحكمة الإدارية هذا الشرط سنة 2014)، وهي كلّها شروط تحدّ من حرية الترشح.
في الوقت عينه تعدّدت مظاهر تدخل السلطة التنفيذية في سير العمل القضائي، من ذلك حلّ المجلس الأعلى للقضاء واستحواذ وزيرة العدل على كل صلاحياته خارج الأطر القانونية. وقد أدانت جمعية القضاة هذا التوجّه التسلّطي واعتبرته سببا لإفقاد القضاء استقلاليته ولنشر الخوف بين عدد كبير من القضاة (بيان 09/ 09/ 2024). وبالنتيجة تحول القضاء في مناسبات عديدة إلى أداة لتصفية الخصوم السياسيين كما حصل لأغلب المترشحين للرئاسة ولا سيما للمترشح "العياشي الزمال" الذي تجاوزت الأحكام الصادرة ضده حتّى الآن الخمس وعشرين سنة بتهمة "تزييف التزكيات"، بينما يُؤكد بلاغ لأحد فروع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أنّ القضاء لم يتحرك فِعليّا للنّظر في تُهمة من نفس الصّنف ضّدّ المُترشح قيس سعيد.
وفي مؤشّر آخر على التوجّه لإفقاد القضاء دوْرَه، كسُلطة تضمنُ شفافية العملية الانتخابية، رفضتْ الهيئة العليا للانتخابات (التي تمت تسمية أعضائها من قبل الرئيس الحالي) تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية، وهو الهيكل الموكول له وحْدَهُ تاريخيّا البتّ في النزاعات الانتخابية والتي يعترف الجميع بحياديته حتى قبل ثورة 2010.
ولم ينْتهِ الأمرُ عند هذا الحدّ، بل أقدمَ نوابُ البرلمان المُوالي لمسار 25 جويلية على تنقيح القانون الانتخابيّ وذلك بسَحْب اختصاص النّظر في النّزاعات الانتخابية من المحكمة الإدارية وإسناده للقضاء العدلي قبل أسبوعين فقط من إجراء الانتخابات، بل وخُتم هذا القانون خلال ساعات من قِبَلِ الرئيس سعيد ليَصْدَرَ بسرعة في الرائد الرسمي ليُصبح نافذا.
ولهذا أجمعتْ كلُّ مكوّنات المجتمع المدني ذات العلاقة بالشأن الانتخابي على اعتبار ذلك تجاوزا صارخا للمعايير الدولية المعمول بها في مجال الانتخابات. جاء هذا في بيانات جمعية القضاة (03 سبتمبر 2024)، والمكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل (22/09/ 2024) أبرز نقابة عمالية. واعتبرت "الشبكة التونسية للحقوق والحريات"، التي تضم أكثر من عشرين جمعية ومنظمة وتسعة أحزاب ديمقراطية، ذلك تمهيدا للتلاعب بنتائج الانتخابات ودعت إلى التظاهر احتجاجا على ذلك.
بعد استفراد الرئيس قيس سعيّد بالسلطة بعد 25 جويلية 2021 شهدت الساحة السياسية التونسية إضعافا مقصودا للمؤسسات ذات العلاقة بمراقبة الانتخابات. كان من أبرز مؤشراته التخلّي عن قاعدة انتخاب الهيئة المشرفة على الانتخابات وإقرار تعيين رئيسها وعدد من أعضائها من قبل الرئيس الحالي؛ وتُتهم هذه الهيئة بإضافة شروط تفصيلية وترتيبية حدّت من حرية الترشح ووسّعتْ من السلطة التقديرية للإدارة التنفيذية في خدمة الرئيس.
في السياق عينه، عانتْ "الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري" الموكول إليها مراقبة وسائل الإعلام تجميدا واقعيا رغم غياب قرار مُعلن بذلك. وكان من تبعات ذلك تحول الإعلام إلى أداة للترويج إلى "مشروع" الرئيس وآرائه في الوقت الذي تم فيه غلق الباب في وجه الرأي المخالف سواء من الأحزاب أو حتى المنظمات والجمعيات الوطنية.
بالتزامن مع ذلك تزايد التضييق على الحريات العامة والفردية وبصورة خاصة حرية التعبير والتنظيم، وهذا باعتماد مراسيم وقوانين زجرية (أبرزها المرسوم 54) وتمّ بمقتضاها إدانة العشرات من المواطنين بسبب انتقادهم سياسة الرئيس أو معاونيه وحُكم على الكثير منهم بالسجن. كما عاشت البلاد تضييقا غير مسبوق على الجمعيات ذات الصلة بمراقبة الانتخابات بحجج مختلفة وهو ما يفسر التدهور الكبير لعدد المراقبين من جمعيات المجتمع المدني في مكاتب الاقتراع يوم 6 أكتوبر إذ تراجع من 27 ألف في انتخابات 2014 إلى 1707 سنة 2024 حسب بعض المصادر.
وفي مسعى لخلق فراغ سياسي يستفيد منه الرئيس المنتهية ولايته تعمدت السلطة التنفيذية التضييق على عمل الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية من خلال فرض إجراءات صارمة تحد من قدرتها على التعبير عن مواقفها أو تنظيم أنشطتها بحرية. فقد تمّ إيداع عدد من قادة الأحزاب وراء قضبان السجون بتهم فضفاضة غير ثابتة مثل "التآمر" منذ قرابة السنيْن بدون محاكمة. وخلال فترة الحملة الانتخابية اعتُقل العشرات من النّشطاء السياسيين، وهوما دفع الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية "أنياس كالامار" إلى اعتبار أنّ السلطات التونسية " تشن هجومًا واضحًا قبيل الانتخابات على ركائز حقوق الإنسان وسيادة القانون، وتتقاعس عن الوفاء بالتزامات البلاد الدولية في مجال حقوق الإنسان، وتقوض المبادئ الأساسية للعدالة والإنصاف" ( 17/ 09/ 2024).
في استخلاص نهائيّ، هناك توافق واسع على ان الانتخابات الأخيرة جرت في إطار سياسي لم يسمح بحرية الدعاية الانتخابية وبتساوي الحظوظ بين المترشحين، فكانت نتائجه محسومة مسبقا. وليس هذا رأي المنظمات الحقوقية الوطنية مثل "الشبكة التونسية للحقوق والحريات" فحسب، بل عبّر عن هذا الموقف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان "فولكر تورك"، في تصريح له بتاريخ 15 أكتوبر2024، اعتبر فيه أن الانتخابات جاءت في "سياق من الضغوطات" على المجتمع السياسي والمدني، وحثّ السلطات التونسية على "الشروع في إصلاحات تتعلّق بسيادة القانون... بشكل يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان".
ويبقى المجتمع المدني بمختلف مكوناته في انتظار ما سيُفصح عنه الرئيس عن مستقبل توجهاته السياسية، متأرجحا بين الأمل في صفحة جديدة تستجيب لتطلعات الشعب التونسي في دولة مدنية تحترم حقوق الإنسان في بُعدها الكوني الشامل ومُصدّقا ما عبّر عنه بعض مقرّبي الرئيس بعد الانتخابات بإمكانية فتح أفق جديد؛ ومتخوفا من تواصل الحكم الفرداني والسياسة القائمة على تهميش أغلب مكونات المجتمع الحيّة متقوقعا وراء شعارات عامة تقسّم المواطنين أكثر مما توحدهم.
احدث المنشورات
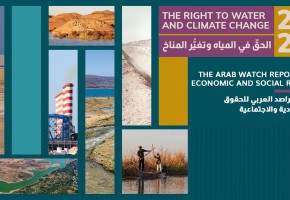
2025 - راصد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في البلدان العربية، الحق في المياه وتغيّر المناخ
